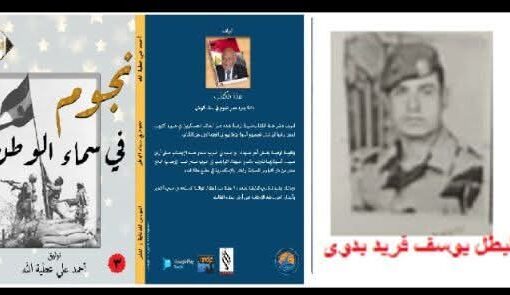أوتو غروس – المحلل النفسي الأناركي
بقلم / د. حنان حسن مصطفي
طريقة خطيرة
كان تصوير فينسنت كاسل للدكتور أوتو غروس في فيلم “المنهج الخطير” مؤثرًا للغاية. مع ذلك، لا يكشف هذا الفيلم الكثير عن شخصية أوتو غروس الحقيقية – الذي، على الرغم من عيوبه الكثيرة، نجح في الجمع بين اهتماماته بشتيرنر، ونيتشه، وفرويد، وكروبوتكين، و”الثورة الجنسية”، والنسوية، والحزب الشيوعي الألماني (في بداياته ذات التوجه الشيوعي اليساري). كما كان له تأثير كبير على يونغ، وكافكا، ودادا برلين. [/strong][br]
[strong]إليكم مقال شيق بقلم غوتفريد هوير، ومقال كلاسيكي بقلم غروس نفسه يصف الإمكانات الثورية للتحليل النفسي، قبل سنوات من رايخ، وماركوز، وفروم، ولاينغ:[/strong
[strong]الشيطان تحت الأريكة: القصة السرية للأخ التوأم ليونغ – جوتفريد هوير[/strong]
قال أوتو غروس عام ١٩١٣: “لقد اختلطتُ بالفوضويين فقط، وأعلنتُ نفسي فوضويًا”. “أنا محلل نفسي، ومن تجربتي، اكتسبتُ فكرة أن النظام القائم… سيء… ولأنني أريد تغيير كل شيء، فأنا فوضوي” (بيرز/ستيلزر ١٩٩٩، ص ٢٤)”. كان أول محلل نفسي يربط التحليل بالسياسات الراديكالية، وكتب: “علم نفس اللاوعي هو فلسفة الثورة” (غروس ١٩١٣ج). لذا، عندما كتبت كولين كوفينغتون مؤخرًا: “التحليل أداة أساسية للثورة (كوفينغتون ٢٠٠١، ص ٣٣١)”، كانت تُكرر ما قاله غروس قبل نحو ٩٠ عامًا. لم يكن مجرد محلل نفسي، بل كان فوضويًا نفسيًا، وبالتالي يُمثل الإمكانات التخريبية للتحليل، مما أكسبه… لقب “الشيطان تحت الأريكة” (راولف 1993).
على الرغم من أن غروس لعب دورًا محوريًا في نشأة ما نسميه اليوم الحداثة، بتأثيراته الواسعة في التحليل النفسي والطب النفسي والفلسفة والسياسة الراديكالية وعلم الاجتماع والأدب والأخلاق، إلا أنه ظلّ مجهولًا تقريبًا حتى يومنا هذا. ففي عام ١٩٢١، أي بعد أقل من عام من وفاته، وصفه الكاتب النمساوي أنطون كوه بأنه “رجل لا يعرفه إلا قلة قليلة بالاسم – باستثناء حفنة من الأطباء النفسيين ورجال الشرطة السرية – ومن بين هؤلاء القلة فقط أولئك الذين نتف ريشه لتزيين مؤخراتهم” (كوه ١٩٢١، ص ١٦-١٧). واليوم، لا يزال معظم المحللين النفسيين لم يسمعوا قط بأوتو غروس، أو تقتصر معرفتهم على: “أليس هذا هو من أصيب بالفصام؟” إلى حد كبير، هذا نتيجة تأريخ تحليلي وصفه إريك فروم، عن حق، بأنه “ستاليني” (فروم ١٩٥٧، ص ١٣٣): إذ يصبح المنشقون أشخاصًا غير حقيقيين ويختفون من السجلات. هذه الممارسة المتمثلة في تطهير التاريخ تجعل قصة أوتو غروس سرية: وكان من المأمول ألا نعرفها أبدًا.
ومع ذلك، قال آدم فيليبس مؤخرًا: “لا مستقبل للتحليل النفسي إذا لم يُرِد البحث في أماكن أخرى عن التجديد، وخاصةً إذا لم ينظر إلى الأماكن التي يُريد استبعادها. فبمنطقه الخاص، هناك حيث توجد الحياة، وهناك حيث يوجد الفعل” (فيليبس ١٩٩٧، ص ١٦٤).
وُلد التحليل النفسي كأداة لبناء مستقبل أفضل بالانتقال من الحاضر إلى الماضي. إنه “نظرة إلى الوراء نحو المستقبل” (هاندي ٢٠٠٢). ما كُبت يعود بقوة، وهكذا يُخلق الماضي من جديد باستمرار. للتاريخ الوظيفة نفسها تمامًا على المستوى الجماعي. يُطلق عليه المؤرخ إدموند جاكوبيتي “تأليف ماضٍ مفيد – التاريخ كسياسة معاصرة” (جاكوبيتي ٢٠٠٠). وإدراكًا لهذا، دعوني آخذكم “إلى حيث يكمن الفعل” – لننظر إلى الجانب المكبوت من التاريخ التحليلي، وهو أوتو غروس.
بالطبع، لم تكن قصته سرًا دائمًا. ففي العقد الأول من القرن الماضي، أشاد أعظم علماء التحليل النفسي بأوتو غروس أشد الثناء. ففي عام ١٩٠٨، كتب فرويد إلى يونغ قائلًا: “أنت الوحيد القادر على تقديم مساهمة أصلية؛ ربما باستثناء أوتو غروس” (فرويد/يونغ ١٩٧٤، ص ١٢٦). وبعد بضعة أشهر، وبعد أن خضع غروس لتحليل نفسي مع يونغ، والذي أصبح أحيانًا ما نسميه اليوم تحليلًا متبادلًا، رد يونغ على فرويد قائلًا: “اكتشفتُ في غروس جوانب عديدة من طبيعتي، حتى أنه بدا لي في كثير من الأحيان بمثابة أخي التوأم” (المرجع نفسه، ص ١٥٦). لم يذكر توماس كيرش (كيرش ٢٠٠٠) غروس في دراسته الحديثة عن “اليونغيين”، مع أنه، في ضوء هذه المشاعر التي عبر عنها يونغ، يُمكن وصف غروس بأنه اليونغي الأول. حتى أن الكاتب إميل سزيتيا (1886-1964) ذهب إلى حد وصف غروس بأنه “صديق الدكتور فرويد والأب الفكري للبروفيسور يونغ” (سزيتيا، ص 211). وحتى عام 1986، كتب الباحث البارز في التحليل النفسي يوهانس كريميريوس عن مركز يونغ للتحليل النفسي عام 1909، قائلاً: “إنه لا يزال تلميذًا كاملًا لأوتو غروس” (كريميريوس 1986، ص 20). لذا، يُمكننا وصف يونغ بأنه غروسيّ مبكر. في عام 1910، كتب فيرينزي إلى فرويد عن غروس: “لا شك أنه من بين من تبعوك حتى الآن، هو الأهم” (فرويد/فيرينزي 1993، ص 154). كتب إرنست جونز في سيرته الذاتية: “كان جروس أول معلم لي في تقنية التحليل النفسي” (جونز، 1990، ص 173) ووصفه بأنه “أقرب نهج إلى المثل الرومانسي للعبقري الذي قابلته على الإطلاق” (نفس المصدر).
[strong]التغلب على الأزمة الثقافية – أوتو غروس[/strong]
سيكولوجية اللاوعي هي فلسفة الثورة: أي أنها مُقدّر لها أن تصبح لأنها تُثير التمرد في النفس، وتُحرّر الفرد من قيود لاوعيه. إنها مُقدّرة لجعلنا قادرين على الحرية داخليًا، ومُقدّرة لتهيئة الأرضية للثورة.
إن إعادة التقييم الفريدة لجميع القيم، والتي سيمتلئ بها المستقبل القريب، تبدأ في هذا الزمن الحاضر بتفكير نيتشه في أعماق الروح، وباكتشاف فرويد لما يُسمى بتقنية التحليل النفسي. هذه الأخيرة منهج عملي يُمكّن لأول مرة من تحرير اللاوعي للمعرفة التجريبية: أي أنه أصبح من الممكن لنا الآن معرفة أنفسنا. وبهذا تولد أخلاق جديدة، ترتكز على الضرورة الأخلاقية للسعي إلى المعرفة الحقيقية عن الذات وعن الآخرين.
ما يُطغى على هذا الالتزام الجديد بتقدير الحقيقة هو أننا حتى اليوم لم نعرف شيئًا عن السؤال الأهم بلا منازع – سؤال ما هو جوهري وجوهري في كياننا، في حياتنا الداخلية، في ذواتنا وفي حياة إخواننا البشر؛ لم نكن حتى في وضع يسمح لنا بالبحث في هذه الأمور. ما نتعلمه هو أن كل واحد منا، كما هو عليه اليوم، لا يمتلك ولا يُدرك إلا جزءًا يسيرًا من كل ما تتضمنه شخصيته النفسية.
في كل نفس بلا استثناء، تنقسم وحدة الكل العامل، وحدة الوعي، إلى قسمين، حيث انفصل اللاوعي عن نفسه ويحافظ على وجوده من خلال إبقاء نفسه بعيدًا عن توجيه الوعي وسيطرته، بعيدًا عن أي نوع من المراقبة الذاتية، وخاصة تلك الموجهة إلى نفسه.
يجب أن أفترض أن معرفة المنهج الفرويدي ونتائجه المهمة منتشرة بالفعل. منذ فرويد، نفهم أن كل ما هو غير مناسب وغير كافٍ في حياتنا العقلية هو نتائج تجارب داخلية أثار محتواها العاطفي صراعًا شديدًا فينا. في وقت تلك التجارب – وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة – بدا الصراع مستعصيًا على الحل، وتم استبعادها من استمرارية الحياة الداخلية كما تعرفها الأنا الواعية. منذ ذلك الحين، استمرت في تحفيزنا من اللاوعي بطريقة مدمرة ومعارضة لا يمكن السيطرة عليها. أعتقد أن ما هو حاسم حقًا لحدوث الكبت يكمن في الصراع الداخلي … وليس فيما يتعلق بالدافع الجنسي. الجنس هو الدافع العالمي لعدد لا حصر له من الصراعات الداخلية، وإن لم يكن في حد ذاته ولكن كموضوع لأخلاق جنسية تقف في صراع لا حل له مع كل ما هو ذو قيمة وينتمي إلى الإرادة والواقع.
يبدو أنه على المستوى الأعمق قد ترجع الطبيعة الحقيقية لهذه الصراعات دائمًا إلى مبدأ شامل واحد، إلى الصراع بين ما ينتمي إلى الذات وما ينتمي إلى الآخر، بين ما هو فردي بطبيعته وما تم اقتراحه علينا، أي ما تم تعليمه أو فرضه علينا بطريقة أخرى.
إن هذا الصراع بين الفردية والسلطة التي اخترقت أعماق ذاتنا ينتمي إلى فترة الطفولة أكثر من أي وقت آخر.
تزداد المأساة تفاقمًا كلما ازدادت فردية الشخص ثراءً، وعززت طبيعته الخاصة. كلما بدأت القدرة على مقاومة الإيحاءات والتدخلات وظيفتها الوقائية مبكرًا وبقوة، كلما تعمق الصراع الداخلي وتفاقم. الطبائع الوحيدة التي تُنجى هي تلك التي يكون فيها الاستعداد للفردية ضعيفًا جدًا، وقليل القدرة على المقاومة، بحيث تستسلم، إن صح التعبير، للضمور وتختفي تمامًا تحت ضغط الإيحاءات من البيئة الاجتماعية وتأثير التعليم – طبائع تتكون دوافعها التوجيهية في النهاية بالكامل من معايير تقييم وعادات رد فعل غريبة ومتوارثة. في مثل هذه الشخصيات الرديئة، يمكن أن تدوم صحة ظاهرية معينة، أي أداء سلمي ومتناغم للنفس ككل، أو بالأحرى، لما تبقى منها. ومن ناحية أخرى، فإن كل فرد يقف بأي شكل من الأشكال أعلى من هذه الحالة الطبيعية المعاصرة للأشياء ليس، في ظل الظروف الحالية، في وضع يسمح له بالهروب من الصراع المرضي وتحقيق صحته الفردية، أي التطور المتناغم الكامل لأعلى إمكانيات شخصيته الفردية الفطرية.
يُفهم من كل هذا أن هذه الشخصيات، مهما كان مظهرها الخارجي – سواءً أكانت معارضة للقوانين والأخلاق، أو تقودنا إيجابيًا إلى ما هو أبعد من المتوسط، أو تنهار داخليًا وتمرض – كانت تُنظر إليها باشمئزاز أو تبجيل أو شفقة على أنها استثناءات مزعجة يسعى الناس إلى إقصائها. وسيتضح اليوم أن هناك بالفعل مطلبًا بقبول هؤلاء الأشخاص باعتبارهم أصحاء، ومحاربين، وتقدميين، والتعلم منهم ومن خلالهم.
لم تنجح أيٌّ من الثورات في التاريخ المُدوّن في ترسيخ حرية الفرد. جميعها باءت بالفشل، وفي كل مرة، باعتبارها مُقدّمةً لبرجوازية جديدة، انتهت إلى رغبة مُتسرّعة في الالتزام بالمعايير العامة. لقد انهارت لأن ثائر الأمس كان يحمل السلطة في داخله. الآن فقط يُمكن إدراك أن جذر كل سلطة يكمن في الأسرة، وأنّ الجمع بين الجنس والسلطة، كما يتجلّى في الأسرة الأبوية السائدة حتى اليوم، يُقيّد كل فرد.
لطالما صاحبت أوقات الأزمات في الثقافات المتقدمة، حتى الآن، شكاوى من تفكك روابط الزواج والحياة الأسرية… لكن لم يكن الناس ليجدوا في هذا “الميل اللاأخلاقي” صرخة إنسانية أخلاقية تؤكد على الحياة، تطالب بالخلاص. غرق كل شيء في الدمار والخراب، وظلت مشكلة التحرر من الخطيئة الأصلية، ومن استعباد المرأة من أجل أطفالها، دون حل.
ثوري اليوم، الذي يتسلح بعلم نفس اللاوعي ويرى مستقبلًا حرًا وسعيدًا للعلاقة بين الجنسين، يُناضل ضد أبشع أشكال الاغتصاب، ضد الأب وحق الأب. الثورة القادمة هي ثورة من أجل حق الأم.[strong]* [/strong]لا يهم الشكل الخارجي والوسيلة التي ستُحقق بها.
(من [em]Die Aktion[/em]، أبريل 1913، أعيد طبعه في [em]Anarchism[/em]…، المجلد 1 ص 281، روبرت جراهام.)
[[قوي]* ملاحظة حول “شيوعية حق الأم”[/قوي]
زعم أوتو غروس أن الاغتصاب الذي أسس النظام الأبوي هو “الخطيئة الأصلية” الحقيقية، وأن “بنية الحضارة برمتها منذ تدمير نظام حق الأم الشيوعي البدائي خاطئة”. كما جادل بأن “التحرر الحقيقي للمرأة، وتفكيك الأسرة التي يحكمها حق الأب من خلال تعميم رعاية الأمومة، يصب في المصلحة الحيوية لكل فرد من أفراد المجتمع، ويمنحه أقصى درجات الحرية” (سبرينغر في كتاب “الثورات الجنسية”، ص ١١٨؛ بيتر ديفيز، “أسطورة الأمومة والحداثة”، ص ٢٥٤-٢٥٦).
إن سجل غروس الضعيف في تربية أطفاله يُضعف آرائه حول رعاية الأطفال. لكنه بالتأكيد أخذ القضية على محمل الجد على المستوى الفكري. بل إن الفقرة الأخيرة من مقاله الأخير تتضمن العبارة التالية: “المهمة: جعل الخلايا الفردية في الجسد الاجتماعي موضع تحريض وتخريب. بدء معركة ضد مبدأ الأسرة، أي ضد عائلة الحق الأبوي السائدة، نيابة عن الحق الأمي الشيوعي” (ب. بيتيكاينن، كيميائي الطبيعة البشرية، ص 91).
استمد غروس هذه الأفكار من يوهان باخوفن، المؤرخ في القرن التاسع عشر، الذي كتب: “إن نهاية تطور الدولة تشبه بداية الوجود الإنساني. وتعود المساواة الأصلية أخيرًا. ويفتح العنصر الأمومي ويغلق دورة كل شيء إنساني” (أغسطس بيبل، المرأة في ظل الاشتراكية، الفصل الثامن).
مستوحىً من ماركس، اهتم إنجلز أيضًا اهتمامًا بالغًا بأفكار باخوفن، وكذلك أفكار لويس هنري مورغان، مدعيًا أن: “إعادة اكتشاف الأجيال الأصلية ذات الحق الأمومي كمرحلة تمهيدية للأجيال ذات الحق الأبوي للشعوب المتحضرة لها نفس الأهمية لتاريخ المجتمع البدائي التي لنظرية التطور لداروين في علم الأحياء، ونظرية فائض القيمة لماركس في الاقتصاد السياسي” (أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة، ص 35). واصل ماركسيون مثل بلوخ وبنيامين ورايخ هذا الاهتمام بباخوفن، وكتب إريك فروم عن “الطابع المادي الديمقراطي للمجتمعات الأمومية” (أزمة التحليل النفسي، ص 149). ومع ذلك، مع استمرار خطر الثورة الاجتماعية حتى ثلاثينيات القرن العشرين، أرادت المؤسسة الأنثروبولوجية دحض جميع هذه الأفكار. أوضح برونيسلاف مالينوفسكي أفكاره عندما قال:
لقد أكدت مدرسة كاملة من علماء الأنثروبولوجيا، منذ باخوفن فصاعدًا، أن العشيرة الأمومية كانت المؤسسة المنزلية البدائية… برأيي، كما تعلمون، هذا غير صحيح تمامًا. لكن فكرة كهذه، بمجرد أخذها على محمل الجد وتطبيقها على الظروف الحديثة، تُصبح خطيرة للغاية. أعتقد أن العنصر الأكثر اضطرابًا في الاتجاهات الثورية الحديثة هو فكرة إمكانية جعل الأبوة والأمومة جماعية. فإذا وصلنا إلى حدّ إلغاء الأسرة الفردية كعنصر محوري في مجتمعنا، فسنواجه كارثة اجتماعية لا تُقارن بالاضطرابات السياسية للثورة الفرنسية والتغيرات الاقتصادية للبلشفية. لذا، فإن السؤال حول ما إذا كانت الأمومة الجماعية مؤسسة قائمة على الإطلاق، وما إذا كانت ترتيبًا متوافقًا مع الطبيعة البشرية والنظام الاجتماعي، له أهمية عملية كبيرة. ( ن. ألين، القرابة البشرية المبكرة ، ص 70).
في السنوات الأخيرة، تشير الدراسات الأنثروبولوجية والوراثية التي أُجريت على مجتمعات الصيد والجمع الأفريقية إلى أن المجتمع البشري المبكر ربما كان قائمًا على الإقامة الأمومية والنسب الأمومي ( ألين، ص 80-2، 186 ؛ سارة هردي، الأمهات وغيرهن). علاوة على ذلك، في العديد من مجتمعات الصيد والجمع البسيطة، تتسم رعاية الأطفال بطابع جماعي أكثر، وتتمتع النساء بسلطة أكبر، مقارنةً بالمجتمعات الزراعية. لذا، ربما كان باخوفن ومورغان وماركس وإنجلز وغروس أكثر صوابًا من المؤسسة الأنثروبولوجية في القرن العشرين.
بطبيعة الحال، لا يزال يتعين علينا أن نرى ما إذا كان تنبؤ غروس بـ “ثورة من أجل حق الأم”، أو تنبؤ ماركس، وهو تنبؤ مشابه، بـ “الأزمة القاتلة للرأسمالية [التي تؤدي إلى] … عودة المجتمع الحديث إلى شكل أعلى من النوع الأكثر قدماً”، سوف يتحقق في القرن الحادي والعشرين ( [strong][EM]MECW[/EM][/strong] المجلد 24، ص 357، 350 ).]
[strong]دراسة سيرة حياة أوتو جروس – جوتفريد هوير[/strong]
وُلِد أوتو غروس في 17 مارس 1877 في غنيبينغ، ستيريا، النمسا. كان والده هانز غروس (1847-1915) أستاذًا في علم الإجرام، وأحد أبرز الخبراء العالميين في هذا المجال. أما والدته فهي أديل، المعروفة قبل الزواج بريمان (1854-1942).
تلقى غروس تعليمه في الغالب في مدارس خاصة، وأصبح طبيبًا عام ١٨٩٩، وفي عام ١٩٠١ سافر كطبيب بحري إلى أمريكا الجنوبية، حيث أصبح حينها مدمنًا على المخدرات. بين عامي ١٩٠١ و١٩٠٢، عمل طبيبًا نفسيًا وطبيبًا، ونشر أولى أبحاثه، وتلقى أول علاج له – ربما على يد يونغ – لإدمان المخدرات في عيادة بورغولزلي في زيورخ. وفي نفس الفترة تقريبًا، تعرف على فرويد.
في عام 1903 تزوج غروس وعُرض عليه كرسي في علم النفس المرضي بجامعة غراتس في عام 1906. انتقل غروس وزوجته فريدا (ني شلوفر، 1876-1950) إلى ميونيخ وعاشا أيضًا في أسكونا بسويسرا. في عام 1907 وُلد ابنهما بيتر († 1946) بالإضافة إلى ابن ثانٍ، يُدعى أيضًا بيتر († 1915)، من علاقته بصديقة مقربة لزوجته، إلسي جافي، ني فون ريشتهوفن. في نفس العام، كان لدى غروس أيضًا علاقة عاطفية مع شقيقة إلسي، فريدا ويكلي، التي تزوجت لاحقًا من دي إتش لورانس. تحدث غروس في المؤتمر الدولي الأول للتحليل النفسي في سالزبورغ في عام 1908 وتلقى مزيدًا من العلاج في بورغولزلي حيث تم تحليله بواسطة سي جي يونغ – وبدوره، قام بتحليل يونغ. أوقف غروس التحليل، وشخّصه يونغ – انتقامًا على ما يبدو – بالفصام. كان هذا يتناقض مع تشخيص كلٍّ من فرويد ويونغ الأصلي للعصاب الوسواسي (فرويد/يونغ ١٩٧٤، ص ١٥١-١٥٢). كما أنه يختلف عن تشخيص ستيكل، الذي حلل غروس عام ١٩١٤ (ستيكل ١٩٢٥). مؤخرًا، قام إيمانويل هورويتز، كاتب سيرة غروس الأول، والذي شغل لسنوات منصب يونغ في مستشفى بورغولزلي كرئيس مسجلي الطب النفسي، بمراجعة جميع مذكرات الحالات والتقارير المتاحة، ليس فقط من يونغ وستيكل، بل أيضًا من قِبَل الأطباء النفسيين الذين قيّموا حالة غروس عام ١٩١٣ (بيرز/ستيلزر ١٩٩٩/٢٠٠٠)، وخلص إلى أنه لا يوجد في هذه الوثائق ما يبرر تشخيص الفصام (هورويتز ٢٠٠٢). وخلص إلى أن:
[em]أن علاج يونغ لغروس لم يكن ناجحًا، وبدلًا من الاعتراف بالهزيمة، حاول يونغ إلقاء اللوم على مرض غروس، وليس علاجه، في الفشل. بدلًا من قبول التشخيص الأصلي للعصاب، الذي وافق عليه فرويد، قال يونغ إن غروس مصاب بمرض عقلي عضال*، مما ألصق به وصمة المرض العقلي مدى الحياة[/em] (في مايكلز ١٩٨٣، ص ٦٣).
لا يزال عمق مشاعر يونج السلبية المستمرة واضحًا في الرسالة التي كتبها إلى فيتلز بعد أكثر من 25 عامًا (في هوير 2001، ص 670، 681-2).**
في عام 1908 ولدت ابنة جروس كاميلا († 2000) من علاقته بالكاتبة السويسرية ريجينا أولمان، التي أصبحت فيما بعد تلميذة لريلكه.
كان لغروس تأثيرٌ بالغٌ على جيلٍ كاملٍ من الكُتّاب، من بينهم فرانز كافكا وروبرت موزيل وفرانز ويرفل. في عام ١٩١٣ في برلين، اعتقل والده، مُستندًا إلى تشخيص سي جي يونغ، غروس ووُضع في مصحةٍ نفسيةٍ بالنمسا. وبحلول وقت إطلاق سراحه، وبعد حملةٍ صحفيةٍ دوليةٍ أطلقها أصدقاؤه، كان غروس قد بدأ العمل كطبيبٍ نفسيٍّ في المستشفى. ووُضع تحت وصاية والده الذي تُوفي عام ١٩١٥، عندما كان غروس طبيبًا عسكريًا في أوروبا الشرقية. بالتعاون مع فرانز يونغ وآخرين، نشر غروس مجلةً بعنوان “الطريق الحر” (Die freie Strasse) كـ”عملٍ تمهيديٍّ للثورة”، وأثر على راؤول هاوسمان وهانا هوش وغيرهما من الفنانين الذين أسسوا دادا برلين. بدأ علاقةً مع ماريان كوه، وفي عام ١٩١٦ رُزقا بابنةٍ اسمها صوفي. توفي غروس متأثرًا بالتهاب رئوي في 13 فبراير 1920 في برلين بعد أن عُثر عليه في الشارع جائعًا ومتجمدًا. كتب فرانز يونغ: “لقد انفجر نجم مناضل عظيم ضد النظام الاجتماعي، ثم انطفأ، ثم تلاشى. لم يحن الوقت بعد” (ف. يونغ 1991، ص 91). وعلق أوتو كاوس، وهو صديق آخر له، قائلاً: “لقد نشأ على يديه خيرة الثوار الألمان وتأثروا به مباشرةً” (1920، ص 55). في عالم التحليل النفسي، لم يكتب فيلهلم ستيكل – الذي كان منبوذًا آنذاك – سوى تأبين قصير (ستيكل، 1920). بعد أربع سنوات، أعلن إرنست جونز وفاة غروس في المؤتمر الدولي الثامن للتحليل النفسي في سالزبورغ (جونز 1924، ص 403).
اعتبر غروس التحليل النفسي لفرويد استمرارًا لفلسفة نيتشه. على سبيل المثال، نسب إلى نيتشه إدراكه للتأثير الممرض للمجتمع على الفرد – ما أسماه غروس الصراع بين ما هو خاص بالفرد وما هو خاص بالآخر. ومن وجهة نظر غروس، طوّر فرويد بعد ذلك رؤية نيتشه أكثر باكتشافه التأثير الممرض للعواطف المكبوتة (غروس ١٩٠٧، ص ٤٧-٤٨). وسرعان ما بدأ يشكك في تأكيد فرويد على أن الجنسانية هي السبب الوحيد للعصاب، ورأى أن الأمراض متجذرة في ميول أكثر إبداعًا وغائية في اللاوعي.
اعتبر غروس […] الثنائية الجنسية أمرًا مسلمًا به، ورأى أنه لا يمكن لأي رجل أن يعرف سبب حب امرأة له إذا لم يكن على دراية بعنصره المثلي. بلغ احترامه للحرية السيادية للبشر حدًا لم يقتصر فيه على الاعتراف بحقهم في المرض كتعبير عن احتجاج مشروع على مجتمع قمعي […]، بل امتد إلى الاعتراف برغباتهم في الموت أيضًا، وبصفته طبيبًا، ساعد في تحقيقها أيضًا. وقد حوكم […] بتهمة المساعدة على الانتحار[/em] (سومبارت ١٩٩١، ص ١١١).
في نضاله ضد النظام الأبوي بجميع مظاهره، تأثر غروس، على ما يبدو، بأفكار باخوفن حول النظام الأمومي. كتب عام ١٩١٣: “الثورة القادمة ثورة من أجل الحق الأمومي”. دافع غروس عن حرية المرأة ومساواتها، ودعا إلى حرية اختيار الشركاء وأشكال جديدة من العلاقات التي تصورها خالية من استخدام القوة والعنف. وربط بين هذه القضايا والهياكل الهرمية في السياق الأوسع للمجتمع. بالنسبة لغروس، كان التحليل النفسي سلاحًا في ثورة ثقافية مضادة لإسقاط النظام القائم، وليس وسيلة لإجبار الناس على التكيف معه بشكل أفضل. وكتب أن التحليل النفسي “مُدعو لتمكين الحرية الداخلية، مُدعو كتحضير للثورة” (غروس ١٩١٣ج، العمود ٣٨٥، التشديد OG).
قبل جيل كامل من فيلهلم رايش، وقبل هربرت ماركوز بأربعين عامًا، كان أوتو غروس هو الرجل الذي وضع في ممارسته العلاجية النفسية الأسس النظرية لـ”الثورة الجنسية” (يُقال إن المصطلح مشتق منه، [فيرفل ١٩٩٠، ص ٣٤٩]) – نظرية تحرير الإمكانات الجنسية للإنسان كشرط أساسي لأي تحرر اجتماعي أو سياسي” (سومبارت ١٩٩١، ص ١٠٩-١١٠). شدد غروس على الترابط الجدلي بين التغيير الداخلي الفردي والتغيير السياسي الجماعي. يلخّص المحلل الثقافي نيكولاس سومبارت ذلك قائلاً:
كانت أطروحة غروس الأولى: إن تحقيق البديل الأناركي للنظام الأبوي للمجتمع يجب أن يبدأ بتدمير هذا الأخير. وقد أقرّ دون تردد بممارسته هذا – وفقًا للمبادئ الأناركية – من خلال الترويج لـ”القدوة”، أولًا بأسلوب حياة مثالي يهدف إلى تحطيم قيود المجتمع في داخله؛ وثانيًا كمعالج نفسي، من خلال محاولته تحقيق أشكال جديدة من الحياة الاجتماعية تجريبيًا من خلال تأسيس علاقات وجماعات غير تقليدية (كما في أسكونا، حيث طُرد منها بتهمة إثارة “العربدة”)…[/em]
[em]أطروحته الثانية: من يريد أن يغير هياكل السلطة (والانتاج) في مجتمع قمعي، عليه أن يبدأ بتغيير هذه الهياكل في داخله وأن يستأصل “السلطة التي تسللت إلى داخله”[/em](سومبارت 1991، ص 110 – 111).
لقد أدرك جروس الطريقة التي تعكس بها هياكل الأسرة التي تنتهك الفرد هياكل المجتمع الأبوي وكان أول من تعاطف بعمق مع الطفل في هذا الصراع.
بلغ اهتمام غروس بالقضايا الأخلاقية ذروته في مفهوم “غريزة المساعدة المتبادلة الفطرية” (غروس 1919أ، ص 682) التي وصفها بأنها “الغريزة الأخلاقية الأساسية” (غروس 1914، ص 529)”. في عام 1919، نشر غروس كتاب “الاحتجاج والأخلاق في اللاوعي” (غروس 1919أ). لم ينشر يونغ حول هذا الموضوع إلا في أواخر حياته (يونغ 1958؛ 1959). كان غروس يشير صراحةً إلى كروبوتكين واكتشافه لمبدأ المساعدة المتبادلة في مجال علم الأحياء. تُعدّ التبادلية مفهومًا جوهريًا في الفكر الأناركي. قبل 150 عامًا، استخدم برودون مصطلح “التبادلية” للإشارة إلى العلاقة الحرة بين مجموعات متساوية قائمة على التبادل. شرح كروبوتكين هذا المفهوم في كتابه “المساعدة المتبادلة، عامل من عوامل التطور” (كروبوتكين ١٩٠٤)، الذي نُشر لأول مرة في إنجلترا عام ١٩٠٢. ويبدو أن الباحثين المعاصرين في علم الأحياء والأنثروبولوجيا وعلم الوراثة يؤكدون هذه النظرية، وفقًا لمقال نُشر مؤخرًا في صحيفة الغارديان، كتبت فيه ناتالي أنجييه عن “لماذا لا نستطيع مساعدة بعضنا البعض”: “ليس من النبل أن نكون لطفاء مع إخواننا البشر فحسب، بل هو أمر متأصل في جيناتنا” (أنجييه ٢٠٠١). وكان غروس أول محلل يُدخل هذا المفهوم الأخلاقي في نظرية التحليل النفسي وممارساته.
من بين أقوى مساعي الإنسان تجاه إخوانه البشر، والتي تبدأ منذ السنوات الأولى، بل وحتى أشهر حياته، سعيٌّ علاجيٌّ في جوهره. إن النسبة الضئيلة من البشر الذين يكرّسون حياتهم المهنية لممارسة التحليل النفسي… إنما يُعبّرون صراحةً عن تفانٍ علاجيٍّ يشترك فيه جميع البشر.
هذا ليس كروبوتكين ولا جروس، بل هارولد سيرلز (1979، ص 380) يكتب في عام 1975 عن “المريض كمعالج لمحلله”.
مع الفيلسوف الراديكالي ماكس شتيرنر، رأى غروس جوهر الصراع بين الذات والآخر. وتحدى خضوع ممارسة التحليل النفسي للنموذج الطبي في سعيها إلى موضوعية غير منخرطة في العلاقة الشخصية بين المحلل والمريض. وفي معارضة لتوصية فرويد بأن يعمل المحلل كما لو كان “مرآة معتمة” (فرويد 1912، ص 118)، أشار غروس إلى ما أسماه “إرادة التواصل”. واعتبر أن هذا “يتعارض مع إرادة القوة، ويجب كشفه باعتباره التناقض الأساسي بين النفس الثورية والنفسية البرجوازية المتكيّفة، ويجب تقديمه باعتباره الهدف الأسمى والحقيقي للثورة” (غروس 1919ب). ويجب النظر إلى هذه الأفكار في ضوء التطورات المبكرة فيما أصبح يُعرف لاحقًا بنظرية العلاقات الموضوعية (راجع سوتي 1933؛ فيربيرن 1952). إن موقف جروس يسبق موقفي سوتي وفيربيرن ويمكن اعتباره رائداً في هذا المجال.
كان تأثير غروس على سي جي يونغ كبيرًا. فبعد تحليله لغروس عام ١٩٠٨، والذي تطور أحيانًا إلى تحليل متبادل، كتب يونغ كتاب “أهمية الأب” في مصير الفرد بالاشتراك مع غروس – مع أنه أنكر في الطبعات اللاحقة تعاونه معه (يونغ ١٩٠٩/١٩٤٩، ص ٣٠٤، ملاحظة ٨). كما استند يونغ في تمييزه بين أنماط الشخصية المنفتحة والانطوائية إلى مفاهيم نشرها غروس قبل عشرين عامًا (يونغ ١٩٢٠، ص ٢٧٣-٢٨٦، ٤١٨، ٥٠٨).
في إعادة صياغة لنيتشه، قال يونغ إن “كل نظرية نفسية هي في المقام الأول […] اعتراف ذاتي” (يونغ ١٩٣٤، الفقرة ١٠٢٥). أرى أن “الاعتراف” بتجربة شخصية وردت في كتاب يونغ “علم نفس النقل” هو التحليل المتبادل مع غروس قبل عشرين عامًا من بدء دراساته الخيميائية التي أدت إلى مفهومه للتبادلية. وقد اتضح مدى تأثير ذلك عليه من خلال رسائله إلى فرويد آنذاك، وهو ما يتضح من أسلوب يونغ: “اكتشفتُ في غروس جوانب عديدة من طبيعتي، حتى أنه بدا لي في كثير من الأحيان كأخٍ توأم” (فرويد/يونغ ١٩٧٤، ص ١٥٦). ألا تشبه هذه الكلمات تلك التي استخدمها لاحقًا لكشف الدلالات السريرية للرسائل الخيميائية التي تصف تجربة العلاقة بين الخيميائي و”الآخر” (الخبير، الأخت)؟
في التحليل الفردي، قد تنبثق قضايا مهمة من اللاوعي أولاً على شكل تمثيلات، قبل أن تُستوعب وتُدمج بوعي. ولعلّ التحليل المتبادل بين يونغ وغروس كان تمثيلاً مؤثراً، تمثيلاً أدى، مع مرور الوقت، إلى صياغة يونغ الجذرية اللاحقة لعلاقة النقل كإجراء جدلي ينخرط فيه كلا الشريكين على قدم المساواة، وبلغت ذروتها في مخطط عام ١٩٤٤ (يونغ ١٩٤٦، ص ٢٢١).
[قوي]مُحنِّك (مُحلِّل، واعي)… أخ (صبور، واعي)[/قوي]
[قوي] أنيما (محلل، لاواعي)… أنيموس (مريض، لاواعي)[/قوي]
في هذا الرسم التخطيطي، يكون الوعي واللاوعي لدى كل من المحلل والمريض في تواصل مستمر كأنداد على المستوى الشخصي وكذلك على المستوى الداخلي.
وهكذا، في سياق تطور النظرية حول جوهر العلاقة التحليلية، ثمة خطوط تنبع بوضوح من تحليل غروس المتبادل مع يونغ. هذه الخطوط، المرتبطة، في حالة غروس، بمفهوم المساعدة المتبادلة الأناركي (كروبوتكين ١٩٠٤)، تقود، عبر فيرينزي، إلى ما يُطلق عليه بعض المحللين النفسيين اليوم اسم “التفاعل بين الذات” (دن ١٩٩٥).
أعتقد أن تجربة التحليل المتبادل مع غروس لعبت دورًا هامًا في انفصال يونغ عن فرويد. في ذكرياته، كنقطة تحول في علاقته بفرويد، يستذكر يونغ اللحظة التي رفض فيها فرويد، بعد مرور عام تقريبًا على تجربته التحليل المتبادل مع غروس، مثل هذه العلاقة (يونغ ١٩٦١، ص ١٨١-١٨٢).
لا يقتصر تأثير أفكار غروس على التبادلية على مجال التحليل. فقد اكتشفتُ مؤخرًا أن مارتن بوبر كان على دراية بعمل غروس – وأدانه بشدة (بوبر ١٩١١) – قبل أن يطور مبدأه الحواري الخاص لعلاقة الأنا والأنت (هوير ٢٠٠٣ب). وهناك أيضًا صلة واضحة بـ “الوضع المثالي للكلام” عند هابرماس.
هناك عدد من أحجار الزاوية الأخرى لعلم النفس التحليلي التي يمكننا أن نجد آثارًا وصياغات أولية لها في عمل جروس. لا يمكن إثبات أن لها تأثيرًا مباشرًا على يونغ بمعنى أنه لا يوجد اعتراف من يونغ بجروس فيما يتعلق بهذه الأفكار. ولكن هل يمكن توقع ذلك، إذا كان يونغ، كما ذكرت، قد أزال لاحقًا الإشارة إلى جروس التي اعترفت بتأليفه المشترك في الأفكار المعبر عنها في [em]تأثير الأب … [/em] (راجع أعلاه)، وبالتالي تزوير السجل عمدًا؟ وبالطبع، فإن هذه الآثار والصيغ الأولية التي أشير إليها، ليست سوى ذلك وليست مفاهيم مكتملة تمامًا كما هو الحال في أعمال يونغ اللاحقة. حتى يُسمح بالوصول الكامل إلى جميع أوراق يونغ، كل ما يمكن ذكره هنا هو تشابه سابق لفكر يونغ.
وجّه غروس أفكاره حول العلاقة نحو عالمٍ أطلق عليه يونغ لاحقًا اسم “العالم الواحد” أو “العالم الخيالي” (صموئيل 1989، ص 161-172)، وهو الترابط الكامن بين جميع الكائنات، وهو ما يُطلق عليه صموئيل، مُشيرًا إلى وينيكوت، “المجال الثالث” (المرجع نفسه، ص 167). يُستخدم هذا المصطلح، وهو أيضًا “المجال الثالث التحليلي”، لوصف مجال الخبرة بين مُكوّني العلاقة. ونظرًا لتأثير غروس على بوبر، فمن اللافت للنظر أن صموئيل يُشير إلى بوبر أيضًا في هذا السياق (المرجع نفسه). ومثل بوبر من بعده، لم يُفرّق غروس بين العلاقات الشخصية والعلاقات في المجال الديني. بل إنه تحدّث عن العلاقات باعتبارها تُشكّل الجوهر الروحي. في عام ١٩١٣، كتب غروس عن “العلاقة كطرف ثالث، تُعتبر دينًا” (غروس ١٩١٣ب، العمود ١١٨٠). ويواصل القول إنه، بهذه الطريقة، فإن العلاقة
[em]يتضمن التزامًا [تقريبًا: إكراهًا] تجاه التفرّد. هذا الالتزام هو إظهار تلقائي لجميع إمكانيات التجربة، والقدرة على الحفاظ على كل الدفء النفسي الذي يسعى نحو دفء نفسي عام وشامل (نفس المرجع).[/em]
ويختتم جروس هذا النص القصير بقوله:
إن الالتزام بهذه العلاقة الناتج عن نقاء التجربة هو أساس عضوي ونفسي لشكل جديد من أشكال الحياة والإيمان والرغبة ومجتمع الحياة (Lebensgemeinschaft) الذي سوف يملأ المستقبل (نفس المرجع، العمود 1181؛ التأكيد مني، GH).
في العام نفسه، صرح جروس بأن الجنسانية “ليست متطابقة مع الفرد، بل هي الثلث الأعظم النقي” (جروس 1913أ، العمود 1142).
يرتبط بمفهوم يونغ عن “العالم الخارجي” مبدأان أساسيان آخران في علم النفس التحليلي، نجدهما مُصاغين مسبقًا في أفكار غروس. أولهما هو هوية الشخصي الخاص والجماعي السياسي، كما يُعبّر عنه، على سبيل المثال، في مصطلح “الثورة الجنسية” نفسه، الذي صاغه غروس قبل نحو خمسين عامًا من عودة هذا الفكر إلى الظهور في الحركة النسوية في سبعينيات القرن الماضي. في أعمال يونغ، نجد تعبيرًا لهذا الفكر في مخطط محاضرات تافيستوك عام ١٩٣٥، حيث يصوّر النفس في دوائر متحدة المركز، من طبقاتها الخارجية – “المجال النفسي الخارجي” كما سماه – إلى أعمق مناطقها – ما يُسمى “المجال النفسي الداخلي”. في هذا الرسم البياني، يقع اللاوعي الشخصي وكذلك اللاوعي الجمعي في وسط الرسم البياني، ويشغلان نفس المساحة (CG Jung 1935، الفقرة 91، الشكل 4).
المفهوم المهم الثاني المرتبط بـ “unus mundus” في أعمال يونغ هو “مبدأ الربط السببي” الذي أطلق عليه لاحقًا اسم التزامن (CG Jung 1952). في ملخصه لعلم نفس غروس قبل حوالي ثلاثين عامًا، كتب فرانز يونغ: “يصبح المرض، وحتى القدر والمصادفة، رمزًا يمكننا تتبع ظروفه الشاملة تحليليًا” (F.Jung 1921، ص 203؛ التشديد مني، GH). يبدو جليًا أن أفكار غروس سلكت مسارًا مشابهًا لمسار أفكار يونغ بعد عقود.
كان غروس أيضًا أول من ربط التحليل بالمجال الديني والروحي. وقد صرّح يوهانس نول (هوير ٢٠٠٣أ)، أحد تلامذة أوتو غروس اللاسلطويين، والذي أصبح لاحقًا أحد محللي هيرمان هيسه، عام ١٩١١ بأن التحليل النفسي لا جدوى منه إن لم يُتوّج بالصلاة (نول ١٩١١، ص ٨٣-٨٤). بالنسبة لغروس، وصف مفهوم “العربدة” المجال الذي يُمكن فيه تحقيق التحرر الفردي والجماعي في إطار طقوس أمومية. وهكذا، أصبحت فكرة “العربدة” مصطلحه لتقديس السياسة الراديكالية.
اعتبر غروس الجسد والعقل شيئًا واحدًا لا ينفصل، وكتب أن “كل عملية نفسية هي في الوقت نفسه عملية فسيولوجية” (غروس ١٩٠٧، ص ٧). وبذلك، “ينضم إلى صفوف الباحثين الذين يدحضون تقسيم العالم إلى عالمين مادي وروحي-فكري. فبالنسبة لهم، الجسد والروح تعبيران عن عملية واحدة، وبالتالي لا يمكن رؤية الإنسان إلا بشكل كلي وككيان متكامل” (هورويتز ١٩٧٩، ص ٦٦).
تبنى المحللون اللاكانيون لاحقًا بعض أفكار غروس حول دور اللغة. لكن تأثيره لم يقتصر على التحليل النفسي. فقد وُجدت روابط بين كتاباته في الطب النفسي وكتاب “مناهضة الطب النفسي” للينغ وكوبر – وقد وُصف غروس نفسه بأنه “مناهض للطب النفسي” (هورفيتز ١٩٧٨، ص ١١١؛ دفوراك ١٩٧٨، ص ٥٣) – وأعمال فوكو ونظريات جوديث بتلر حول الجندر (راجع تشولوج ٢٠٠٠). وقد ثار جدل حاد بين غروس وماكس فيبر، مما أثّر أيضًا على علم الاجتماع.
[قوي]الاستنتاج[/قوي]
كمساهمة في عودة المكبوت، قدمتُ مقدمةً موجزةً عن حياة وعمل أوتو غروس وتأثيره على النظرية التحليلية والممارسة السريرية. استُبعد سي جي يونغ في الغالب من تاريخ أفكار التحليل النفسي وخطابها المعاصر. أما أوتو غروس، بدوره، فلا يُذكر في التحليل النفسي ولا في علم النفس التحليلي. قبل ما يقرب من أربعين عامًا، عندما نُشرت ما يُسمى بالسيرة الذاتية ليونغ، كتب وينيكوت في مراجعته أنها “توفر للمحللين النفسيين فرصةً، ربما تكون الأخيرة، للتصالح مع يونغ. إذا فشلنا في التصالح مع يونغ، فنحن نُعلن أنفسنا مناصرين، مناصرين لقضية زائفة” (وينيكوت، ١٩٦٤، ص ٤٥٠). لم يتصالح التحليل النفسي مع يونغ بعد. متى سينتهز كلٌّ من الفرويديين واليونغيين الفرصة أخيرًا للتصالح مع أوتو غروس؟
[em]جمعية أوتو غروس الدولية[/em] (http://www.ottogross.org/.)
[قوي] ببليوغرافيا[/قوي]
أبراهام، ك. (1905) ‘أوتو جروس: ‘ Zur Biologie des Sprachapparates”، [em]Münchner Medizinische[/em] [em]Wochenschrift،[/em] رقم 1: 38-39
Adler, A. (1997)[em] Über den nervösen شخصية. Grundzüge einer vergleichenden – علم النفس الفردي والعلاج النفسي[/em]. Kommentierte textkritische Ausgabe، eds. KH Witte، A. Bruder-Bezzel،
R. Kühn، Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht. أنجير، ن. (2001). لماذا لا يسعنا إلا أن نساعد بعضنا البعض، [م]الجارديان، SaturdayReview،[/م] 22 سبتمبر، ص. 3.
ج. بيرزي، د.ك. ستيلزر (1999 / 2000). Befund und Gutachten، أد. أ. هانسن. [em]جيجنر[/em]، العدد 3، ديسمبر/ يناير، برلين، ص 24 – 36. بوبر، م. (1911). جوتاشتن [م].[/م] في: المرجع نفسه، الطبعة: [م] غوستاف لانداور. Sein Lebensgang في بريفين.[/م] فرانكفورت: Rütten & Loening، 1929، ص. 383.
تشولوج، ب. (2000). التحليل النفسي والتداعيات السياسية المترتبة على أوتو جروس، إريك موهسام جيسيلشافت، أد.، [م] مرجع سابق[/م]، ص 125 – 134.
كوفينجتون، سي. (2001). مستقبل التحليل، في [م] مجلة علم النفس التحليلي[/م]، المجلد. 46، ص 325 – 334
كريميريوس، ج. (1986). فورورت. في A.Carotenuto، الطبعة: [م]سابينا سبيلرين. Tagebuch einer heimlichen Symmetrie[/em].. فرايبورغ ط. br.: كور، الصفحات من 9 إلى 28. Dehmlow, R. & G. Heuer. (1999). [م] أوتو جروس. Werkverzeichnis und Sekundärschrifttum[/em]. هانوفر: لورينتيوس.
ديهملو، آر آند جي هوير، محرران. (2000). [م]1. الدولي أوتو جروس كونجرس. باوهاوس-أرشيف، برلين.[/م] ماربورغ، هانوفر: LiteraturWissenschaft.de، Laurentius.
ديهملو، آر آند جي هوير، محرران. (2003). [م]3. الدولي أوتو جروس كونجرس. ماكسيميليان- جامعة لودفيغ، ميونيخ. [/em]ماربورغ: LiteraturWissenschaft.de. دان، J. (1995). التداخل في التحليل النفسي. مراجعة نقدية. [م] المجلة الدولية للتحليل النفسي، [/ م] المجلد. 76، ص 723 – 738.
دفوراك، ج. (1978). كوكين وموترخت. Die Wiederentdeckung von Otto Gross (1877 – 1920). [em]المنتدى الجديد[/em], Jg. 25، هيفت 295/96، ص 52 – 64.
ايسلر، ك. (1983). [em]انتحار فيكتور تاوسك[/em]. نيويورك: مطبعة الجامعات الدولية. ايسلر، ك.، إي. هورويتز (1979/80). [em]المراسلات[/em]. أرشيف أوتو جروس، لندن. بي كويست هورويتز. [قوي] [/ قوي] إريك موهسام جيسيلشافت، أد. (2000). [م] الأناركية والتحليل النفسي من بداية العشرين. Der Kreis um Erich Mühsam und Otto Gross.[/em] Schriften der Erich-Mühsam- Gesellschaft, Heft 19. لوبيك: Erich-Mühsam-Gesellschaft. فيربيرن، WRD (1952). [em]دراسات التحليل النفسي للشخصية[/em]. لندن: روتليدج وكيجان بول. Ferenczi, S. (1920) ‘Otto Gross: Drei Aufsätze über den Internalen Konflikt’، [em]Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse،[/em]Vol. السادس: 364-366.
فرويد، س. (١٩١٢). توصيات للأطباء الممارسين للتحليل النفسي. SE XII، ص ١١١-١٢٠. فرويد، س.، س. فيرينزي (١٩٩٣). مراسلات سيغموند فيود وساندور فيرينزي، المجلد الأول، ١٩٠٨-١٩١٤. المحررون: إي. برابانت، إي. فالزيدر، وبي. جيامبيري-دويتش، كامبريدج، ماساتشوستس، ولندن: مطبعة بيلكناب التابعة لجامعة هارفارد. فرويد، س.، سي. جي. يونغ (١٩٧٤). رسائل فرويد/يونغ. مراسلات سيغموند فرويد وسي. جي. يونغ. تحرير دبليو. ماكغواير، ترجمة ر. مانهايم وآر. إف. سي. هال. لندن: مطبعة هوغارث وروتلدج وكيجان بول، 1974. فروم، إي. (1957) رسالة إلى إيزيت دي فورست، 31. أكتوبر، في إي. فالزيدر (1998) “مسائل شجرة العائلة”، [م] مجلة علم النفس التحليلي[/م] 43: 127-54.
جرين، م. (1999) [م]أوتو جروس. المحلل النفسي الفرويدي، 1877-1920. الأدب والأفكار. [/ م] لويستون، كوينستون، لامبيتر: مطبعة ميلين. جروس أو. (1907). [em]اللحظة الإيديولوجية الفرويدية وأفكارها المجنونة- الاكتئابية في إيرسين كريبيلين[/em]. لايبزيغ: فوجل. جروس أو. (1913 أ). Anmerkungen zu einer neuen Ethik. في: [م] يموت أكتيون، [/ م] المجلد. الثالث، العقيد. 1141 – 1143.
الإجمالي. O. (1913 ب). Notiz über Beziehungen. في: [م] يموت أكتيون، [/ م] المجلد. الثالث، العقيد. 1180 – 1181. جروس أو. (1913 ج). Zur Überwindung der kulturellen Krise، [em]Die Aktion،[/em] المجلد. الثالث، العمود 1384-387.
جروس أو. (1914). Über Destruktionssymbolik، في [em] Zentralblatt für Psychoanalyse und Psychotherapie، [/em] المجلد. الرابع، العدد 11/12، ص.[م]525 -534.[/م]
جروس، أو. (1919أ). الاحتجاج والأخلاق غير لائقين. [em]يموت إردي[/em]. المجلد. 1، رقم 24، 15 ديسمبر، س 681 – 685. (الاحتجاج والأخلاق في اللاوعي. ترجمة ت. جوندل، [م] النقد الألماني الجديد [/ م]، المجلد 10، 1977، ص 105 – 109.)
جروس، O. (1919ب). Zur funktionellen Geistesbildung des Revolutionärs (حول التعليم الفكري الوظيفي للثوريين).[em]Räte-Zeitung, Erste Zeitung der Hand-und Kopfarbeiterräte Deutschlands, [/em]Vol. 1، لا. ٥٢، بيلاج (ملحق).
هاندي، س. (٢٠٠٢). الفيل والبرغوث. نظرة إلى الماضي نحو المستقبل. لندن: هاتشينسون. هوير، ج. (١٩٩٩). أوتو غروس، المجلة الدولية للتحليل النفسي، المجلد ٨٠، ص ١٧٣-١٧٤.
هوير، ج. (٢٠٠١). شقيق يونغ التوأم: أوتو غروس وكارل غوستاف يونغ. مع رسالة لم تُنشر حتى الآن بقلم سي جي يونغ، مجلة علم النفس التحليلي، المجلد ٤٦، العدد ٤، ٦٥٥-٦٨٨.
هوير، ج. (2003 أ). Der Außenseiter der Außenseiter. جديد über einen Unbekannten. Entdeckungen zu Johannes Nohl (1882 – 1963): الحياة والعمل. (Werkverzeichnis und Sekundärliteratur. In: [em]Juni. Zeitschrift für Literatur und Politik,[/em] No. 36/37 (تحت الصحافة). Heuer, G. (2003b). “Ganz Wien in die Luft sprengen?… Das wäre ja wunderbar!” Otto Gross und der Anarchismus. In: G. Dienes & R. Rother, eds.: [em]Die Gesetze des Vaters. [/em]Wien: Böhlau, pp. 114 – 125.
Heuer, G., ed. (2002).[م] 2. دولي مؤتمر أوتو جروس، بورغولزلي، زيورخ[/em]. ماربورغ: LiteraturWissenschaft.de. هومانز، ص. (2000). مقدمة. تي بي كيرش 2000، [م] مرجع سابق، [/ م] ص. هورويتز، E. (1978). أوتو جروس – Von der Psychoanalyse zum Paradies. في: هارالد زيمان، الطبعة: [م] مونتي فيريتا. بيرج دير واهرهايت. الأنثروبولوجيا المحلية مثل Beitrag zur Wiederentdeckung einer neuzeitlich sakralen Topographie[/em]. ميلان: إليكتا، ص 107 – 116.
هورويتز، إي. (1979). [م] أوتو جروس. باراديز-سوشر زويشن فرويد ويونغ. زيورخ: سوركامب. هورويتز، إي. (٢٠٠٢). أوتو غروس – هل هو مصاب بالفصام؟ في: هوير، جي.، محرر: [em]المرجع السابق،[/em] ص. ٦٣-٧٥.
جاكوبيتي، إي. إي.، محرر. (٢٠٠٠). [em]تأليف ماضٍ مفيد. التاريخ كسياسة معاصرة.[/em] ألباني: مطبعة جامعة ولاية نيويورك.
جونز، إي. (١٩٢٤). “تقرير في اجتماع العمل، ٢٢ أبريل، بعد الظهر”. إي. جونز وك. أبراهام، “تقرير المؤتمر الدولي الثامن للتحليل النفسي”. [em]نشرة الجمعية الدولية للتحليل النفسي، [/em]المجلد [em]٥،[/em] ص. ٣٩١-٤٠٨.
جونز، إي. (١٩٩٠). [em]مجاني الجمعيات.[/em] نيو برونزويك ولندن: ترانزاكشن. يونغ، سي جي (1909/1949).[em] أهمية الأب في مصير الفرد[/em].[em] [/em]CW 4. لندن: روتليدج وكيغان بول، 1981. يونغ، سي جي (1920). [em]الأنماط النفسية.[/em] CW 6. لندن: روتليدج وكيغان بول، 1981. يونغ، سي جي (1934).[em]رد على الدكتور بالي.[/em]CW 10. نيويورك: مؤسسة بولينجن، 1964. يونغ، سي جي (1935). [em]محاضرات تافيستوك.[/em]CW 18. لندن: روتليدج وكيغان بول، 1986. يونغ، سي جي (1946). [em]علم نفس التحويل. [/em]CW 16. لندن: روتليدج وكيجان بول، 1981. يونغ، سي جي (1952). [em]التزامن. مبدأ ربط لا سببي.[/em]CW 8. لندن: روتليدج وكيجان بول، 1981. يونغ، سي جي (1958). [em]نظرة نفسية للضمير.[/em] CW 10. لندن: روتليدج وكيجان بول، 1981. يونغ، سي جي (1959). [em]الخير والشر في علم النفس التحليلي.[/em]. CW 10. لندن: روتليدج وكيجان بول، 1981. يونغ، سي جي (1963). [em]الذكريات، تأملات الأحلام.[/em]. لندن: كولينز
جونغ، ف. (1921). [em]Von geschlechtlicher Not zur sozialen Katastrofe. [/م]مخطوطة. برلين: كلير يونج أرشيف، Stiftung Archiv der Akademie der Künste. (نُشر لأول مرة كملحق في مايكلز 1983، [em]op.cit.)[/em] K(aus)., O. (1920). Mitteilungen، في [م] Sowjet. [/م]رقم. 8/9، 8 مايو، الصفحات من 53 إلى 57.
كيرش، تي بي (2000). [م] اليونغيون. منظور مقارن وتاريخي. [/م]لندن وفيلادلفيا: روتليدج. كروبوتكين، ب. (1904).[م]Gegenseitige Hilfe in der Tier-und Menschenwelt. [/em]Übersetzt von Gustav Landauer. جرافينو: Trotzdem-Verlag، 1993. (الطبعة الألمانية الأولى 1904. الأصل باللغة الإنجليزية، 1902، [م] المساعدة المتبادلة. عامل التطور.) [/ م]
كوشنهوف، ب. (2002). أوتو جروس إم سبانونجسفيلد من الطب النفسي والتحليل النفسي – من Blickwinkel des Burghölzli. في: Heuer, G., ed.: [em]op.cit.,[/em] الصفحات من 49 إلى 62.[strong] [/strong]Kuh, A.(1921). [م] جودين ودويتشه. عين السيرة الذاتية.[/م] برلين: إريك ريس. مايكلز، جي إي [م] الفوضى وإيروس. تأثير أوتو جروس على اللغة الألمانية[/م] [م]الكتاب التعبيريون: ليونارد فرانك، فرانز يونج، يوهانس آر بيشر،[/م] [م]كارل أوتن، كورث كورينث، والتر هاسنكليفر، أوسكار ماريا جراف؛ فرانز [/ م] [م] كافكا، فرانز فيرفيل، ماكس برود، راؤول هاوسمان وبرلين دادا. [/م]نيويورك: بيتر لانج، 1983.
نوهل، ج. (1911). Fichtes Reden an die deutsche Nation und Landauers Aufruf zum Sozialismus، [em]Der Sozialist[/em]، المجلد. 3، رقم 11، ص 82 – 87. فيليبس، أ. (1997). في A. مولينو، الطبعه، [م] مرتبط بحرية. [/ م] لندن: كتب رابطة مجانية. راولف، يو (1993). Wir Wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. بعد أن أصبح إنسانًا، كان يجب على الرجل أن يتطلع إلى نفسه: جوتفريد كوينزلن رحل عن حضارة الدين الديني اليهودي. (Rezension von: G. Küenzlen، Der neue Mensch”. ميونيخ 1993.) [م] فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج، [/ م] 7 ديسمبر، ص. L15. صامويلز، أ. (1989). [م] النفس التعددية. [/ م] لندن ونيويورك: روتليدج. سيرلز، إتش إف (1979).
المريض كمعالج لمحلله. في المعرف: [م] التحويل المضاد والمواضيع ذات الصلة. أوراق مختارة[/م]. ماديسون: مطبعة الجامعات الدولية، الصفحات من 380 إلى 459.
Sombart, N. (1991). [em]Die deutschen Männer und ihre Feinde. كارل شميت [/ م] – [م] ein deutsches Schicksal zwischen Männerbund und Matriarchatsmythos. [/em]ميونخ، فيينا: كارل هانسر. ستيكل، دبليو (1920). في ذكرى، [م] النفس وإيروس، [/ م] المجلد. 1، ص. 49.
ستيكل، دبليو (1925). Die Tragödie eines Analytikers, in [em]Störungen des Trieb-und Affektlebens. (يموت Parapathischen Erkrankungen